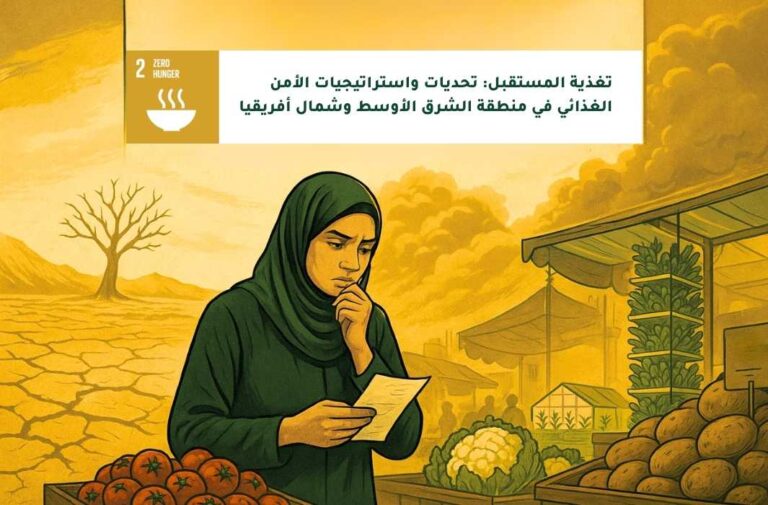على مائدة المستقبل، هل تكفي الفتات؟
في أحد أسواق مدينة شرق أوسطية، حيث تختلط أصوات الباعة بروائح التوابل الزكية، تقف امرأةٌ بقلق بالغ، تتفحّص أسعار السلع الغذائية بعينٍ مرهقة وحسابات دقيقة لميزانية لا تكاد تفي بالاحتياجات اليومية. مشهدٌ ظاهره اعتيادي، إلا أنه يُخفي في طيّاته صورة أعمق وأشد تعقيدًا: صورة منطقة تخوض صراعًا متواصلًا من أجل تأمين الغذاء لسكانها في ظل ندرة الموارد الطبيعية، وتأثيرات تغيّر مناخي متسارعة، واعتماد مفرط على واردات غذائية خارجية.
إن الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يعد مسألة اقتصادية أو بيئية فحسب، بل أضحى قضية استراتيجية تمسّ جوهر الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتمتد آثارها إلى كل بيت، لتشكّل عاملًا حاسمًا في صياغة مستقبل الأجيال القادمة. ومع أنّ هذه المنطقة تحمل في تاريخها إرثًا زراعيًا غنيًا، فإنّ التحديات المعاصرة تفرض عليها إعادة النظر في نماذج الإنتاج والاستهلاك، والسعي نحو حلول مبتكرة ومستدامة تضمن أمنها الغذائي في ظل مشهد عالمي متغيّر.
فك رموز الأمن الغذائي: ما وراء لقمة العيش
لا يقتصر مفهوم الأمن الغذائي على مجرد توافر الطعام، بل يتجاوز ذلك ليشكّل إطارًا متكاملًا يضم أبعادًا اقتصادية واجتماعية وصحية. ووفقًا للتعريف المعتمد في مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، يتحقّق الأمن الغذائي “عندما يتمكّن جميع الأفراد، في جميع الأوقات، من الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى غذاء كافٍ، وآمن، ومغذٍ، يُلبّي احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم الغذائية، بما يضمن لهم حياة نشطة وصحية”.
يستند هذا التعريف الشامل إلى أربع ركائز مترابطة، تُشكّل مجتمعة الأساس الذي تقوم عليه السياسات والاستراتيجيات المعنية بهذا المجال:
- الإتاحة (Availability): وتشير إلى وجود كميات كافية من الغذاء بصورة مستمرة، سواء من خلال الإنتاج المحلي، أو الاستيراد، أو المساعدات الغذائية، أو المخزونات الاستراتيجية.
- إمكانية الحصول (Access): وتُعنى بقدرة الأفراد والأسر على تأمين هذا الغذاء، ليس فقط من خلال الدخل أو القدرة الشرائية، بل أيضًا عبر الوصول الفعلي إلى الأسواق وتجاوز العوائق اللوجستية والجغرافية والاجتماعية.
- الانتفاع (Utilization): ويتعلّق بكفاءة الجسم في استخدام العناصر الغذائية المتاحة، اعتمادًا على جودة الغذاء وتنوعه، وسلامته، وممارسات التحضير والتخزين، وتوفر المياه النقية وخدمات الصرف الصحي.
- الاستقرار (Stability): ويُشير إلى ضرورة استمرارية الأبعاد الثلاثة السابقة بمرور الوقت، وضمان قدرة النظام الغذائي على التكيّف مع الأزمات والصدمات، سواء كانت مناخية مثل الجفاف، أو اقتصادية مثل تقلبات الأسعار، أو سياسية كالنزاعات.
وفي السنوات الأخيرة، أضيفت أبعاد جديدة لهذا المفهوم، أبرزها الاستدامة (Sustainability)، التي تُعنى بالحفاظ على الموارد البيئية للأجيال القادمة، والتمكين (Agency)، الذي يُعزز دور الأفراد والمجتمعات في تشكيل نظمهم الغذائية، بما يضمن عدالة وتشاركية أكبر في القرارات المتعلقة بالغذاء.
وعلى الرغم من التقدّم المحرز عالميًا، ما تزال معضلة الجوع وسوء التغذية قائمة. ففي عام 2022، عانى ما بين 691 و783 مليون شخص من الجوع، وتشير التقديرات إلى أنّ قرابة 600 مليون شخص سيظلون يعانون منه بحلول عام 2030، وهو رقم لا ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. كما تُخفي هذه الأرقام واقعًا أكثر تعقيدًا يتمثّل في “الجوع الخفي”، الناتج عن نقص المغذّيات الدقيقة، إلى جانب الارتفاع المقلق في معدلات السمنة، المرتبطة بانتشار الأغذية المصنعة زهيدة الثمن وضعيفة القيمة الغذائية.
وفي طليعة هذا الجهد العالمي، تأتي أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تضع خريطة طريق لمستقبل أكثر عدالة وازدهارًا. ويحتل الهدف الثاني (SDG 2) “القضاء التام على الجوع” مكانة محورية، إذ لا يقتصر على التعهّد بإنهاء الجوع بحلول عام 2030، بل يمتد ليشمل تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة. إن هذا الهدف بمثابة بوصلة عالمية توجّه السياسات نحو القضاء على كافة أشكال سوء التغذية، من “الجوع الخفي” إلى السمنة، ويؤكد على ضرورة بناء نظم غذائية قادرة على الصمود في وجه الأزمات. وبذلك، فهو لا يمثل مجرد غاية إنسانية، بل إطارًا استراتيجيًا تُقاس على ضوئه فعالية الجهود الوطنية والإقليمية، ومن ضمنها جهود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سباقها نحو تأمين مستقبلها الغذائي.
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بؤرة التحديات المتشابكة
تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيفًا معقّدًا من التحديات المتداخلة، تجعل معركتها من أجل تحقيق الأمن الغذائي أشد تعقيدًا من نظيراتها في مناطق أخرى من العالم. ويُسهم تفاعل هذه التحديات في تكريس واقع هشّ يستدعي مقاربات شاملة ومتكاملة، تعتمد على الابتكار وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية.
- شحّ المياه المزمن: تُعد المنطقة من أكثر مناطق العالم جفافًا، إذ تضم نحو 6.3% من سكان العالم، بينما لا تمتلك سوى 1.4% من موارده المائية العذبة المتجددة. ويُعد نصيب الفرد من المياه في المنطقة الأدنى عالميًا، ويواصل تراجعه سنويًا. كما أن قطاع الزراعة يستهلك ما يزيد عن 80% من الموارد المائية في معظم بلدان المنطقة، ما يفاقم من أزمة المياه ويقلّص من هامش المناورة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
- تغير المناخ بوصفه “مضاعفًا للمخاطر”: تُصنّف المنطقة ضمن “النقاط الساخنة” لتغير المناخ، إذ يُتوقع أن تتجاوز فيها درجات الحرارة معدلات الارتفاع العالمية، مع انخفاض ملحوظ في كميات الأمطار، وزيادة في تواتر وحدّة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف وموجات الحر. ويؤدي ذلك إلى تراجع إنتاجية المحاصيل وزيادة الطلب على مياه الري، ما يُعمّق من الضغوط القائمة على المنظومات الزراعية والمائية.
- الاعتماد الكبير على الواردات: تُعد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر الدول اعتمادًا على استيراد الغذاء، لا سيّما الحبوب الأساسية كالقمح. وتُغطي الواردات الغذائية ما بين 25% إلى 50% من احتياجات الاستهلاك في عدة دول، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، واضطرابات سلاسل التوريد، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 وأزمات الصراعات الجيوسياسية الأخيرة.
- النمو السكاني والتوسع العمراني: تشهد المنطقة نموًا سكانيًا متسارعًا، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الطلب على الغذاء والمياه والطاقة. وفي الوقت ذاته، يؤدي التوسع الحضري غير المنضبط إلى التعدّي على الأراضي الزراعية الخصبة، خصوصًا في المناطق الساحلية ودلتا الأنهار، مما يُقلّص من القدرة على تعزيز الإنتاج المحلي.
- النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار: تساهم الصراعات الممتدة في دول مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا في زعزعة منظومات الأمن الغذائي، عبر تدمير البنية التحتية الزراعية، وتعطيل الأسواق المحلية، وتهجير السكان، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، مما يخلق بؤرًا لانعدام الأمن الغذائي الحاد.
- تدهور الموارد الطبيعية: تواجه الأراضي الزراعية في المنطقة تهديدات مستمرة بفعل التملّح، وتآكل التربة، والتصحر، وهي ظواهر تتفاقم نتيجة تغير المناخ وسوء إدارة الموارد الطبيعية، ما يهدد ديمومة الإنتاج الزراعي.
- فاقد وهدر الغذاء: يُقدّر أن نسبًا مرتفعة من الغذاء تُهدر في المنطقة على امتداد سلسلة القيمة، سواء خلال مراحل الحصاد والتخزين والنقل، أو على مستوى المستهلك النهائي، وهو ما يشكّل إهدارًا مزدوجًا للغذاء والموارد، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحسين وفرة الغذاء وكفاءته.
أهمية استراتيجية: لماذا يُعد الأمن الغذائي شريان الحياة للمنطقة؟
لا يقتصر الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تأمين إمدادات الطعام، بل يتجاوز ذلك ليشكّل حجر الزاوية في استقرار المجتمعات واستدامة التنمية في مختلف أبعادها. ويُعد هذا الملف أولوية استراتيجية تمسّ الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي، كما يتضح في المحاور التالية:
- البُعد الاقتصادي:
إن الاعتماد الكبير على واردات الغذاء يجعل اقتصادات المنطقة عرضة لتقلبات أسعار السلع في الأسواق العالمية، ما ينعكس في ارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة الأعباء على الموازنات العامة، خاصة في الدول التي تعتمد على دعم الأغذية. كما أن سوء التغذية، في أشكاله المختلفة، يُكبّد الاقتصاد خسائر ملموسة نتيجة ارتفاع التكاليف الصحية وانخفاض الإنتاجية. بالمقابل، فإن الاستثمار في تعزيز الإنتاج المحلي المستدام يفتح آفاقًا لخلق فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة، والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية بعيدًا عن القطاعات الريعية. - البُعد الاجتماعي:
يُعد القضاء على الجوع وسوء التغذية هدفًا إنسانيًا ومجتمعيًا ذا أولوية. إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 14% من سكان المنطقة (66.1 مليون نسمة) قد واجهوا الجوع عام 2023، في حين عانى 39.4% (186.5 مليون نسمة) من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد. كما تتجلّى “العبء الثلاثي” لسوء التغذية في ارتفاع معدلات التقزّم والهزال بين الأطفال، ونقص المغذيات الدقيقة، وارتفاع معدلات السمنة. وتُبرز هذه المؤشرات تحديًا مضاعفًا يتمثل في ضرورة ضمان الوصول العادل إلى غذاء صحي وكافٍ، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتعزيز الصحة العامة وبناء رأس مال بشري قادر، وتقليص الفجوات الاجتماعية. وفي هذا السياق، تُظهر الإحصاءات أن نحو 151.3 مليون شخص في المنطقة لم يتمكنوا من تحمل كلفة نظام غذائي صحي عام 2022. - البُعد السياسي:
يُعد الأمن الغذائي قضية سيادية بامتياز، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار السياسي والاجتماعي. وقد أظهرت أحداث مثل انتفاضات “الربيع العربي” (2010–2011) الدور المحوري لارتفاع أسعار الغذاء ونقص الإمدادات في تأجيج الاحتجاجات الشعبية. وفي مجتمعات تُعد فيها أسعار السلع الغذائية الأساسية من القضايا الحساسة سياسيًا، يُمثل الحفاظ على استقرار منظومة الغذاء عاملًا حاسمًا في صون السلم الأهلي واستقرار النظم الحاكمة. - البُعد البيئي:
ترتبط المنظومات الغذائية ارتباطًا وثيقًا بالبيئة، حيث تُعد من بين أبرز القطاعات المؤثرة في التغير المناخي واستهلاك الموارد الطبيعية. وتسهم النظم الزراعية التقليدية في انبعاث الغازات الدفيئة، وتدهور الأراضي، واستنزاف المياه، وفقدان التنوع الحيوي. وفي منطقة شحيحة الموارد كالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبرز أهمية تبنّي ممارسات زراعية مستدامة، تشمل تحسين كفاءة استخدام المياه، والحفاظ على خصوبة التربة، وتقليل الفاقد والهدر، كمدخل رئيسي لضمان الأمن الغذائي طويل الأمد.
استراتيجيات وطنية في مواجهة التحدي: نماذج متنوعة
إدراكًا لهذه التحديات، وضعت دول المنطقة استراتيجيات وطنية متنوعة تهدف إلى تعزيز أمنها الغذائي، مع تركيزات مختلفة تعكس ظروف كل دولة: فعلى سبيل المثال ركزت الإمارات على الريادة العالمية في مؤشر الأمن الغذائي وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. كما باتت تستثمر بشكل مكثف في التكنولوجيا الزراعية المتقدمة والزراعة في بيئات خاضعة للرقابة (CEA) لتعزيز الإنتاج المحلي (خاصة الخضروات والفواكه)، مع الحفاظ على دورها كمركز تجاري عالمي وتنويع مصادر الاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي.
أما عن المملكة العربية السعودية فقد وضعت رؤية واستراتيجية للزراعة، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ضمن رؤية أوسع للتنويع الاقتصادي والاستدامة. وقد ركزت المملكة على زيادة الإنتاج المحلي لسلع محددة (كالدواجن والأسماك والقمح ضمن حدود معينة) باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز الشديد على كفاءة استخدام المياه والاستثمار الخارجي عبر صندوق الاستثمارات العامة (SALIC) لتأمين السلع الأساسية.
في حين أن مصر اعتمدت بشكل كبير على مشاريع استصلاح الأراضي الصحراوية الضخمة (مثل توشكى والدلتا الجديدة) لزيادة الرقعة الزراعية وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية (خاصة القمح). إلى جانب التركيز على تطوير موارد مائية غير تقليدية كمعالجة مياه الصرف الصحي على نطاق واسع وإعادة استخدامها، لمواجهة ضغوط النمو السكاني الهائل والاعتماد على النيل.
وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب الذي طور استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 والتي تمثل تطورًا عن استراتيجية سابقة (مخطط المغرب الأخضر)، حيث تولي اهتمامًا أكبر للاستدامة البيئية، والقدرة على التكيف مع المناخ، وتنمية رأس المال البشري، والإدماج الاجتماعي لصغار المزارعين، إلى جانب أهداف زيادة الإنتاجية والصادرات.
الابتكار والتكنولوجيا: أدوات لتشكيل مستقبل الزراعة في المنطقة
في مواجهة التحديات المعقّدة التي تتهدد الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبرز الابتكار التكنولوجي كعامل حاسم يمكنه إحداث تحوّل نوعي في أنماط الإنتاج الزراعي واستخدام الموارد. وبالنظر إلى محدودية المياه والأراضي الصالحة للزراعة، فإن تبنّي أدوات ذكية ومستدامة بات ضرورة لا رفاهية.
- الزراعة الذكية وتطبيقات التقنيات الرقمية:
تُعدّ الزراعة الذكية من أبرز الحلول الواعدة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة، وتشمل:- الزراعة الدقيقة (Precision Agriculture): تعتمد على استخدام أجهزة استشعار، وطائرات بدون طيار، ونظم تحديد المواقع (GPS) لرصد وتحليل احتياجات كل جزء من الحقل بدقة، مما يسمح بتوزيع المياه والأسمدة بجرعات دقيقة، ويُحسن الإنتاجية ويُقلل الهدر.
- إنترنت الأشياء (Internet of Things – IoT): يُمكّن من ربط أجهزة الاستشعار والمعدات الزراعية بشبكات رقمية لمراقبة التربة والرطوبة ودرجات الحرارة ونمو المحاصيل في الوقت الحقيقي، ما يُسهم في أتمتة عمليات الري والتسميد واتخاذ قرارات فورية قائمة على البيانات.
- تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI): تُستخدم لمعالجة كميات ضخمة من البيانات الزراعية بهدف التنبؤ بمعدلات الإنتاج ومخاطر الآفات والأمراض، وتحسين تخصيص الموارد، بل واستخدام الروبوتات في بعض العمليات الميدانية.
- الطائرات بدون طيار (Drones): أصبحت أداة متعددة الوظائف تُستخدم في المسح الجوي، ومراقبة نمو المحاصيل، وتطبيق المبيدات والأسمدة بدقة عالية، ما يُسهم في تقليل التكاليف وتفادي الاستخدام العشوائي للمدخلات الزراعية.
- تقنية سلسلة الكتل (Blockchain): توفر وسيلة شفافة وآمنة لتتبع المنتجات الغذائية على امتداد سلسلة التوريد، ما يُعزز من سلامة الأغذية، ويحدّ من الغش التجاري، ويُرسّخ ثقة المستهلك في جودة المنتجات.
- حلول المياه المتقدمة:
- تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية: تُمثل خيارًا واعدًا لتقليل تكلفة تحلية مياه البحر وتقليص بصمتها الكربونية.
- إعادة استخدام مياه الصرف الصحي: تُستخدم بعد المعالجة في الري الزراعي، مما يُضيف مصدرًا مائيًا بديلًا يُسهم في تقليل الضغط على المياه العذبة.
- الزراعة في بيئات خاضعة للرقابة (Controlled Environment Agriculture – CEA):
تشمل الزراعة الرأسية والزراعة المائية (Hydroponics)، وتتيح إنتاجًا عالي الكثافة على مدار العام باستخدام مساحات صغيرة وكميات مياه محدودة تصل إلى 98% أقل من الزراعة التقليدية. وتُعد هذه التقنيات واعدة في البيئات القاحلة، رغم ما تواجهه من تحديات متعلقة بالتكلفة الأولية واستهلاك الطاقة.
دروس من العالم وتطلعات للمستقبل
تستطيع المنطقة العربية أن تستفيد من تجارب دول أخرى واجهت تحديات مماثلة، مثل سنغافورة التي تسعى إلى إنتاج 30% من احتياجاتها الغذائية محليًّا بحلول عام 2030، على الرغم من محدودية مواردها. وقد تحقق لها ذلك من خلال التركيز على الزراعة التقنية المتقدمة (Controlled Environment Agriculture – CEA)، والدعم الحكومي القوي، والاستثمار في البحث والتطوير، واعتماد استراتيجية متكاملة تشمل تقليل الفاقد الغذائي، وتنويع مصادر الاستيراد.
إنّ تحقيق الأمن الغذائي المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلّب رؤية شاملة، والتزامًا طويل الأمد، وشراكة فعّالة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية. ويُفترض أن تتركّز الجهود المستقبلية على المحاور التالية:
- تسريع الاستثمار في البحث والتطوير: من خلال ابتكار تقنيات زراعية ومائية تتلاءم مع بيئة المنطقة، وتكون في متناول المزارعين.
- تعميق التعاون الإقليمي: عبر تبادل الخبرات، وتنسيق السياسات، وإدارة الموارد المشتركة بطريقة عادلة ومستدامة.
- دمج مبادئ الاستدامة في صلب السياسات: لضمان عدم تحقيق مكاسب إنتاجية على حساب استنزاف الموارد الطبيعية.
- تمكين الأفراد والمجتمعات: عبر التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، وتقليل الفاقد والمهدر من الغذاء.
خاتمة: من تحدي الندرة إلى ريادة الابتكار
تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مفترق طرق مفصلي، إذ تُواجَه بتحدّيات جسيمة تتعلق بالأمن الغذائي والمائي، تتسم بتعقيداتها وتداخل أسبابها. ومع ذلك، فإن هذه التحدّيات، على شدّتها، تُشكّل في جوهرها دافعًا استراتيجيًا نحو تبنّي مسارات جديدة للابتكار والتحوّل البنيوي.
إن تضافر الإرادة السياسية مع الاستثمارات المدروسة في مجالات التكنولوجيا والمعرفة، إلى جانب تعزيز أطر التعاون الإقليمي، واعتماد مقاربات مستدامة ومتكاملة، من شأنه أن يُحدث تحوّلًا نوعيًّا، يُفضي إلى تحويل أزمات الندرة إلى فرص للنمو وبناء القدرات.
ولا يقتصر الأمر على تلبية الحاجات الآنية للسكان، بل يتعدّى ذلك إلى بناء منظومة معرفية وتقنية تُمكّن المنطقة من الاضطلاع بدور ريادي عالمي في تطوير وتصدير حلول الزراعة والغذاء المستدامة، لا سيّما تلك الملائمة للظروف البيئية القاسية.
وعليه، فإن تحقيق أمن غذائي ومائي مستدام يتطلّب اليوم استثمارًا واعيًا في مفاهيم الابتكار والتكامل، يُمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
..تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…